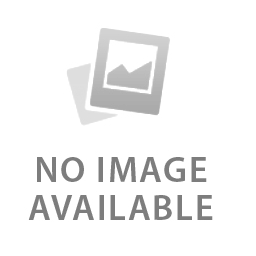

في عام ١٣٠٥، كانت قرية نابيه المتمركزة على تلة نافرة نحو البحر، تضجّ بالحياة تحت حكم الأمير علم الدين سليمان بن زين الدين التنوخي. كانت نابيه ملقّبة بـ "لؤلؤة المراقبة"، ولم تكن مجرد قرية عادية، بل كانت "كرسي" الإمارة ومقرّ خيّالة الأمير التنوخيين الأشاوس.
كان الأمير قد اتّخذ من تلّة مخروطية الشكل، تطلّ بشموخ على الساحل، مقرّاً لسرّه ومرصداً لخيّالته؛ فهي عقدة الوصل الحيوية بين مناطق الغرب والجنوب وكسروان. وكان يرتفع فوق سطح التلّة الدائري برج الإمارة الحصين، الذي اعتُبر من أهم نقاط المراقبة نظراً للموقع الاستراتيجي الفذ للتلة، كما كان البرج محاطاً بسور حجري منيع يلتفّ حول حافته المخروطية.
وتحت السطح، كمن سرداب عميق محفور بين الصخور العملاقة، ليضمّ خزائن الأمير وكنوزه. كان السرداب فسيحاً، مؤلفاً من عدة طبقات تتواصل فيما بينها بدهاليز غامضة تحاكي عروق الأرض، وقد جُهِّز للسكن والدفاع والتخزين في آنٍ واحد.
ولضمان البقاء، حفر الأمير خزاناً كبيراً في أسفل منشأته، وجرّ إليه الماء من نبع القرية بواسطة قساطل فخارية مطمورة في الأرض حمايةً لها من عوامل الطبيعة. ولما كانت التلة أعلى من عين الماء، اعتُمدت آلية هندسية مبتكرة؛ إذ ينساب الماء في القساطل لينصبّ في حفرة عميقة، ثم يعود فيرتفع بقوة الضغط مجدداً نحو خزان المياه.
ثلاثية الصمود
كان لقرية نابيه ثلاثة مواقع دفاعية استراتيجية، شكّلت فيما بينها درعاً لا يُخترق ومثلثاً من القوة والمنعة: راميّا، الرويسة، والشاوية. لم تكن هذه المواقع مجرد نقاط جغرافية على الخارطة، بل كانت نبض الإمارة وحصنها الحصين الذي تكسرت عليه أطماع الغزاة عبر العصور، حيث كان الصخر ينطق بالعزّة، والريح تحمل صهيل خيولٍ لا تستكين.
بينما كانت الرويسة تتربع كـ "برج الإمارة" العالي، مركزاً للقرار ومقراً للقيادة، كانت راميّا هي "الدرع الضارب" الذي يحمي ذلك القرار. في راميّا، كانت الساحات تضجّ بصهيل الخيول وحمحمة الجياد الأصيلة التي نذرها أهلها لحراسة "باب الإمارة الغربي" الواسع. كان الخيّالة الأشدّاء هناك يرقبون بعيون الصقور أيّ غبارٍ يشي بقدوم عدوان من أعماق وادي انطلياس صعوداً نحو مرتفعات الشمّيس، أو تحركٍ مريب من جهة كسروان إذا ما فكّر جيرانهم اللمعيّون بأي خطوة عدائية؛ فكانوا يدركون أن الوصول إلى حمى نابيه أبعدُ من نيل النجوم، وأن أسوارها لا تُطال.
أما "بلاطة الغنمة"، فكانت لها حكاية أخرى من الهيبة والجمال؛ تلك البقعة الصخرية التي كانت تفترش الأرض كبساطٍ أزلي، اتخذها الخيّالة مضاجع لهم ومستراحاً يلملمون فيه تعبهم. ولم يكن المقاتل لِيصمد لولا تأمين ظهره؛ لذا كانت هذه البقعة الصخرية الصلبة أكثر من مجرد مرقدٍ للجنود، بل كانت الشريان التاجي الذي يربط القرية بالعالم الخارجي. فقد كانت ممراً آمناً وسرياً يمتد نحو المتين، ومن فوق تلك الصخور الصماء، كانت تنساب قوافل المؤن والأسلحة، لضمان استمرارية الصمود وبقاء مخازن القلعة عامرة بما يحتاجه الحماة في ليالي الحصار الطويلة، فكانت "البلاطة" رمزاً للأمان وسرّاً من أسرار البقاء في قلب الخطر.
في الطرف الآخر، تبرز "الشاوية" كمرصد الإمارة الأوحد؛ بقعةٌ تزداد مهابةً كلما اقتربت منها نظراً لطبيعة موقعها وشدّة شموخها التي تطاول السحاب. كانت الشاوية تمنح الرقيب قدرةً فائقة على كشف المدى ومراقبة جميع الاتجاهات والدروب الوعرة من مسافات بعيدة لا تطالها العين المجردة. ولم تقتصر شهرتها على العلوّ الفائق، بل عُرف فرسانها ببسالةٍ أسطورية في القتال المفتوح؛ إذ سطروا بدمائهم انتصاراتٍ مدوية في ساحة "الميدان" الشهيرة الواقعة جهة الجنوب، حيث كانت تُحسم المعارك الكبرى وتُصان كرامة الأرض، لتبقى نابيه عصيةً بفضل عيون فرسانها التي لا تنام.
صهيل الشوق
كان "صخر"، وهو فارسٌ ملهَمٌ من أشد رماة منطقة "راميا" بأساً وأسرعهم سهماً، لا يكتمل يومه إلا بوقفةٍ يطيلها عند "العين". هناك، حيث تتفجر المياه من قلب الصخر لتغسل وعثاء الطريق عن خيله، كان يقف على صهوة جواده الأدهم الذي يشاركه الصمت والترقب. لم يكن وقوفه لمجرد ري عطش فرسه، بل كان قلبه هو الظامئ لمرأى الأميرة "نور"، ابنة الأمير "علم الدين"، التي اعتادت عبور هذا الدرب بموكبها المهيب.
كانت "نور" آية في الحسن، رشيقة القوام كأرزةٍ شامخة في أعالي المتن. وجهها مرآة لصفاء الفجر، ببشرةٍ قمحيةٍ لوحتها شمس الجبل برقة، وعينين واسعتين بلون العسل الجبلي المصفى، يحيطهما رموشٌ كثيفة كأنها نبالٌ مستعدة للرمي، تنطق بكبرياء التنوخيين تارة وبحنان الأنثى تارة أخرى. كانت تمر مع حاشيتها يومياً، تتهادى بخطواتٍ مدروسة تفيض أنفة، تشبه في خفتها مشية الخيل الأصيلة التي تكاد قدماها لا تلمسان التراب.
في ذلك اليوم، حدث ما لم يكن في الحسبان؛ تعثرت إحدى خيول القافلة تماماً عند منبع العين، مما أجبر الموكب على التوقف. ترجلت الأميرة "نور" لتستنشق هواء الوادي العليل، فبدت في طلعتها كأنها الشمس إذا انشقت عنها الغيوم. كانت ترتدي "صاية" من الحرير الدمشقي بلون الزمرد، مطرزة بخيوط الذهب التي تلتمع مع كل حركة، وينسدل فوقها عباءة رقيقة من "القصب" المنسوج، شفافة كغلالة من ضباب الجبل. وعلى رأسها كان يرتفع "الطنطور" الفضي المرصع بالمرجان، تتدلى منه طرحة بيضاء من الشاش الرقيق ترفرف خلفها مع النسمات، فتبدو كالقمر حين يستتر خلف سحابة عابرة.
اقتربت بخيلاء من حافة الصخر حيث يتدفق الماء، وعطرها الذي يمزج بين العود وورد الجبل يسبق خطاها. استغل صخر تلك اللحظة الفارقة، فدنا بجواده ببطء حتى أصبح على مسافة لا يسمع فيها سواهما حفيف الشجر. لم تلتفت "نور" إليه مباشرة، بل ظلّت ترقب انعكاس وجهه على صفحة الماء الرقراقة، بينما يدها المزينة بالخواتم الفضية ترتب طرف وشاحها.
بصوتٍ خفيض يملؤه الوجد، قال صخر: "يا ابنة الأمير، انظري إلى هذا الماء الذي ينحدر من العين ليعاند الجاذبية ويصعد عبر القنوات إلى حصنكم في الرويسة.. إنه ليس ماءً فحسب، بل هو وجدٌ تقطّر من روحي، يحمل شوقي إليكِ في كل قطرة تسكن قلاعكم العالية".
التفتت إليه "نور" أخيراً، وبنظرةٍ امتزج فيها دلال الأميرات بليونة المحبين، قالت: "يا صخر، إن خيالك لا يغادر شرفة الرويسة. أرقبه كل ليلة من علياء قصري، وأتساءل: هل يشتاق الفارس للعين أم لصاحبة الحصن؟". كاد قلب صخر أن يتوقف من هيبة الرد، فأكملت بجرأة: "اعلم أن الطيور التي تشرب من هذه العين، تزور شرفتي كل صباح وتخبرني بانتظارك".
وعندما نادى كبير الحرس معلناً استئناف المسير، أسبلت عينيها مودعة، ومضت بخطواتها الواثقة نحو حاشيتها، تاركةً خلفها عبقاً يملأ المكان. صهل الحصان صرخة نصر هزت أركان الوادي، وانطلق "صخر" كالسهم باتجاه "راميا"، والبسمة على وجهه تنثر على جانبي الطريق مروج أزهارٍ برية تفتحت احتفاءً بوعود العيون.
لم تطل ليالي الانتظار؛ فقد أدرك صخر أن الحب خلف الجدران المنيعة يحتاج إلى جسارة تفوق جسارة الحروب. وفي يوم مشهود، جمع صخر أعيان "راميا" وتوجه في موكب مهيب نحو "الرويسة"، ليس غازياً، بل طالباً للقرب. حمل معه أجود أنواع الخيل، وقوسه التي لم تخطئ هدفاً قط، ليقدمها مهراً لمن سكنت روحه.
لم يكن الأمير "علم الدين" غافلاً عما يدور، فقد رأى في صخر نبل الفرسان الذي لا يشترى بالمال. فُتحت بوابات الرويسة العظيمة، واجتمع شمل "العين" بالحصن في عرسٍ لم تشهد الجبال له مثيلاً. ومنذ ذلك الحين، يقال إن مياه تلك العين صارت تجري بقوة أكبر، وكأنها تفتخر بأنها كانت ساعي البريد الصامت الذي ربط بين قلب فارسٍ في الوادي، وأميرةٍ في أعالي الرويسة.
"حملة "الأفرمي
بدأت تطلعات المماليك للتوسّع في بلاد الشام تأخذ منحىً حاسماً بعد تأمين الثغور الساحلية؛ فبعد أن أتمّوا سيطرتهم على الساحل اللبناني وتطهيره من بقايا النفوذ الصليبي، التفتت أنظارهم نحو الجبال العصيّة التي كانت لا تزال خارج سلطنتهم المباشرة. وفي مطلع شهر آذار من عام ١٣٠٥م، برزت شخصية الأمير "جمال الدين أقوش الأفرمي"، نائب السلطنة في دمشق، كقائد محنك لا يعرف الهزيمة، رجلٌ عُرف بصرامته العسكرية وولائه المطلق للعرش المملوكي. صدرت إليه الأوامر السلطانية بتجهيز حملة عسكرية كبرى لإخضاع متمردي الجبال، فخرج من دمشق على رأس جيش عرمرم، مخترقاً سهل البقاع، حيث كان يخطط لكل خطوة بدقة متناهية، واضعاً نصب عينيه بسط سلطة الدولة مهما كلف الثمن.
لم يكن التقدّم سهلاً، فقد دارت رحى معارك ضارية في الممرات الجبلية الوعرة، بينما كان الأفرمي يتقدّم بجيشه الجرار محتلّاً القرى الواحدة تلو الأخرى، ومنكّلاً بكل من أبدى مقاومة، في سياسة تهدف إلى بث الرعب وتأمين خطوط الإمداد. استمر هذا الزحف العسكري الممنهج من ناحية ضهر البيدر، نزولاً نحو الممرات المؤدية إلى بيروت، حيث اتخذ الأفرمي من الساحل مركزاً لإدارة العمليات اللاحقة وتجميع القوات المنتشرة على طول الخط الساحلي اللبناني.
عقد الأفرمي اجتماعاً عسكرياً موسعاً مع قادة الجيوش المرابطة على الساحل، وجرى نقاش مستفيض حول "معضلة جبل المتن". كانت تلال المتن وقراها تشكل العائق الأخير أمام خضوع جبل لبنان بالكامل للمماليك. وبعد استطلاع دقيق للأرض وسماع شهادات الجواسيس، أيقن الأفرمي أن "قرية نابيه" ليست مجرد قرية عادية، بل هي "قفل الجبل" ومفتاح السيطرة على المتن بأكمله. فهي الحصن الحصين للأمير "علم الدين التنوخي"، ذاك القائد الجبلي الصلب الذي كان يمثل رمزاً للمقاومة والأنفة. كان التنوخي رجلاً خبيراً بطباع الجبال، يقود مقاتليه بروحٍ لا تلين، وقد حول نابيه إلى قلعة طبيعية يستحيل اختراقها، معتمداً على ولاء رجاله ومعرفته العميقة بكل صخرة ومنحدر في محيط قريته.
غرق الأمير جمال الدين الأفرمي في تفكير عميق لعدة أيام، يوازن بين خياراته العسكرية الصعبة؛ فالتوجه بجيشه من منطقة أنطلياس صعوداً باتجاه "راميا" كان يبدو في حسابات الحرب أقرب إلى الانتحار الجماعي؛ إذ إن القوات المملوكية ستجد نفسها محصورة في قعر الوادي السحيق تحت رحمة رماة التنوخي، بينما يسيطر المدافعون الجبليون على المرتفعات، مما يجعل جيشه هدفاً سهلاً للنبال والحجارة والويلات التي ستنهال عليهم من كل حدب وصوب. أما خيار البدء باقتحام "تلة الرويسة"، فقد شطبه الأفرمي من خطته سريعاً، نظراً لاستحالة تسلق الجروف الصخرية العمودية التي تحمي التلة، والتي كانت ستجعل من الجنود المماليك أهدافاً مكشوفة تماماً لنيران ورماح رجال التنوخي قبل وصولهم إلى القمة.
أمضى الأفرمي قرابة الأربعة أشهر في الدراسة والتحضير والمناورات، يقيس المسافات ويراقب تحركات خصمه اللدود "علم الدين التنوخي" الذي كان بدوره يراقب تحركات المماليك من أعالي القمم بيقظة تامة. استمر هذا الحال حتى حلّ شهر تموز من عام ١٣٠٥م. عندها، تفتق ذهن الأفرمي عن خطة بديلة تعتمد على الدهاء العسكري والمباغتة بدلاً من المواجهة الرأسية الانتحارية. قرر أن يسلك مساراً غير متوقع، وهو الصعود من جهة "نهر الموت"، متغلغلاً في الوديان العميقة والوعرة تحت جنح السرية التامة، ليلتف هكذا من الخلف، بعيداً عن أعين مراقبي الأمير علم الدين التنوخي، محاولاً اختراق التحصينات الدفاعية من نقطة ضعفٍ ربما لا يتوقعها الخصم، آملاً في كسر صمود نابيه وإخضاعها لسيادة السلطنة في هجوم يجمع بين المكر العسكري المملوكي والبسالة التنوخية المدافعة عن الأرض.
أسرار نهر الموت
لم يكن اختيار الأمير "الأفرمي" لمسار نهر الموت نابعاً من سهولته، بل من شدة خطورته التي جعلت الأمير "علم الدين التنوخي" يستبعده كلياً من حسابات الهجوم المملوكي. كان النهر في ذلك الزمن شرياناً يتدفق بجنون بين جدران جبلية شاهقة، غطتها الأشجار المتشابكة والصخور المنزلقة التي لم تكن تسمح حتى بمرور الضوء إلى قاع الوادي، فبدا وكأنه خندقٌ أبدي من الظلال.
توقفت خيول المماليك عند مدخل الوادي، وساد صمتٌ لم يقطعه إلا هدير المياه المندفعة. سأل الأفرمي أحد أدلائه المحليين عن سر تسمية هذا النهر بهذا الاسم الموحش، فأجابه بلهجة غلب عليها الخوف:
"يا مولاي، إنه وادٍ لا يرحم؛ مياهه تباغت العابرين بفيضانات فجائية تجرف كل ما يعترض طريقها، ومن يضلّ في شعاب غاباته لا يخرج منها أبداً. لقد سمّاه الأقدمون ''نهر الموت'' لأن جباله تبتلع الغزاة، وتلاله لا تعطي أسرارها إلا لأهلها".
لم يهتز الأفرمي، بل أمر جنوده بالترجل عن خيولهم، وبدأوا عملية تسلق مضنية. كانت الأوحال تلتهم أقدام الجنود، والصخور الملساء تجعل من حمل الدروع والسيوف عبئاً يفوق طاقة البشر.
كان المشهد مهيباً؛ آلاف الجنود يزحفون كالأفاعي بين الصدوع الصخرية، يحاولون كتم أنفاسهم وصليل سلاحهم لكي لا يصل صدى صوتهم إلى آذان مراقبي التنوخي المرابطين فوق قمم "نابيه".
وبينما كان الجيش يتغلغل في عمق الوادي، بدأت الطبيعة تفرض حصارها. ضاقت الممرات حتى اضطر الجنود للسير فرادى، وبدأت الانهيارات الصخرية الصغيرة تثير الرعب في قلوب المقاتلين الذين اعتادوا حروب السهول المفتوحة. كان "الأفرمي" يسير في المقدمة، يغرس سيفه في الأرض ليتكأ عليه، وعيناه لا تفارقان القمم العالية. كان يعلم أن أي خطأ في التقدير سيحول هذا النهر إلى مقبرة جماعية لجيشه، ليؤكد النهر مجدداً أحقيته باسمه الدموي.
في الأعلى، كان الأمير " علم الدين التنوخي " يقف على شرفة حصنه في نابيه، ينظر نحو الساحل والوديان السحيقة. كان يشعر ببرودة غريبة تسري في الجو، وكأن الجبل يحاول تحذيره. رغم ثقته بأن "نهر الموت" هو حارس طبيعي لا يمكن اختراقه، إلا أن صمته المطبق ذلك اليوم كان يثير في نفسه ريبة القائد الذي لا ينام.
نجح المماليك، بعد مجهود أسطوري استنزف قواهم، في الوصول إلى نقطة الالتفاف التي تطلّ على نابيه من زاوية لم يتعود أهلها النظر إليها كمصدر للخطر.
لقد استغل " الأفرمي " نقطة الضعف الجغرافية؛ فبينما كان التنوخيون يحصنون الجبهات المواجهة لأنطلياس وكسروان، تركوا جهة الوادي العميقة لحراسة الطبيعة، ظناً منهم أن أحداً لن يجرؤ على تحدي "ملك الموت" الساكن في بطن النهر.
ليلة المماليك
خيم الظلام الدامس على "نهر الموت"، ولم تكن النجوم لتجرؤ على اختراق كثافة الأشجار المتشابكة التي غطت الوادي ككفنٍ أخضر. في تلك الليلة من شهر تموز، وبينما كان جيش الأمير "جمال الدين الأفرمي" قد وصل إلى غابة أشجار مواجهة لقرية نابيه، من ناحية برمانا، واستراحوا بعد طول عناء، أصدر أوامره الصارمة: "لا نيران، لا صهيل، ولا صراخ".
تحول جيش المماليك إلى أشباح صامتة تفترش الحصى الرطب تحت أشجار الصنوبر الشامخة.
جنود وخيول منهكون، يحبسون انفاسهم ويصارعون جفونهم لكي يحافظوا على يقظتهم.
كان " الأفرمي " يجلس في فجوة صخرية، يراقب بصمت التلة المواجهة له، كما خيط الماء الرفيع الذي ينساب تحت قدميه. لم ينم، ولا ندري اذا ما كان متوتراً او لم يكن نعساناً، ولكنه بقي مستيقظاً يعيد رسم خريطة نابيه في ذهنه. كان يدرك أن قراره بالانتقال إلى نابيه هو مقامرة كبرى؛ فإذا اكتشف التنوخيون أمرهم قبل الفجر، سيتحول السفح إلى فخٍ مميت، حيث لن يجد جنوده مكاناً للهرب من السهام المنهمرة من الأعلى.
كان قلقاً لكنه حافظ على ملامحه الجامدة، فهو مصدر ثقة رجاله ونبع بسالتهم، وأي شكّ يُظهره سوف يؤدّي الى خوفهم وتخاذلهم. أرادهم أن يرتاحوا بصمت، ويستجمعوا قواهم بهدؤ قبل أن يأمر بهبوب العاصفة على نابيه.
على المقلب الآخر، كان الأمير "علم الدين التنوخي" يسير فوق أسوار حصنه في الرويسة بينما النيران المشتعلة في مشاعل الحصن ترتعش بفعل نسيم الجبل البارد.
كان سارح الفكر، ينظر إلى البعيد حيناً، ثم يتوقف ويرهف سمعه نحو جهة الوادي.
سأله أحد حراسه: "ما بك يا أمير؟"، فأجاب وعيناه تغوران في الظلام السحيق:
"ثمة صمتٌ غريب يلف النهر الليلة.. الجبل لا يصمت هكذا إلا إذا كان يخنق سراً ما." كان إحساسه غريباً وقلبه ينبض بإيقاع الحرب.
لاحظ أن الساحل ساكن اكثر من اللزوم وكأنه في حالة ترقّب.
أصدر أمره الذي قضى بإرسال جندياً في إتجاه راميّا وآخر باتجاه الرويسة مزوّدين بأوامر تشديد الحراسة على الجبهتين الخلفيتين.
كانت ساعات الانتظار تطول وتثقل على قلب الجنود المماليك وهم يمسحون صدأ الرطوبة عن سيوفهم بقطع من القماش المنهكة، بينما التعب قد بلغ منهم. لكن الخوف من المجهول ومما ينتظرهم أبقى عيونهم ساهرة وشاخصة نحو نابيه.
ساعات طوال، حالكة، صامتة، مقلقة معلقة قد تكون الفاصلة بين الحياة والموت، بين الوجود واللاوجود، أو ربما قد تكون لحظات مفتاح الجبل.
ومع اقتراب خيوط الفجر الأولى، بدأ جنود المماليك يتجهّزون بهدؤ، فالمعركة تدقّ القلوب ولا مجال للتراجع، بعد قليل سوف يكون الموت أو البقاء، الهزيمة أو النصر الذي لن يحقّقه سوى مباغتة التنوخيين في عقر دارهم.
مباغتة سهل الميدان
مع تباشير الفجر الأولى، بدأ نور الصباح ينسلّ ليكتب صفحة جديدة في تاريخ الجبل. بدا المشهد كأنه رداءٌ منسوج من غموض الأيام، ساحر، ناصع، يلفّه غبش متردد. كان الأمير "الأفرمي" قد حدد خطّته النهائية وأبلغها لقادة أفواجه الذين استغرقوا وقتهم في شرحها للجنود. وكان "سهل الميدان" —تلك البقعة المنبسطة نسبياً عند مدخل قرية نابيه، التي كانت تُستخدم عادة لتدريبات خيالة التنوخيين واحتفالاتهم— على موعدٍ ليشهد اليوم أعنف فصول المواجهة.
انطلق الجنود في الصعود الأخير، تتقطع أنفاسهم جهداً، ويغرسون نصال خناجرهم في التربة ليتمكنوا من تسلق المنحدرات الحادة. نال منهم التعب لكن صهرهم التصميم، أضناهم الجوع والعطش لكنهم راهنوا على ريّ ظمئهم بالانتصار. عندما ضربت أشعة الشمس الأولى قمم الأشجار، خرجت طلائع جيش الأفرمي من حافة الوادي السحيق لتجد نفسها فجأة عند أطراف سهل الميدان. كان المشهد مذهلاً ومروعاً في آنٍ واحد؛ فقد التف المماليك تماماً حول الدفاعات الأمامية، وأصبحوا الآن في "ظهر" الحصن، في منطقة لم يظن التنوخيون يوماً أنها ستحتاج إلى سورٍ أو خندق؛ فالميدان تحميه التلال من ثلاث جهات، أما من الغرب فكان نهر الموت هو الحارس المنيع.
طبق الصمت على السهل قبل أن يشقّه صوت بوق مملوكي مدوٍّ، تبعه تكبير ثم صراخ آلاف الجنود وهم يندفعون نحو قلب الميدان. استيقظ مقاتلو الأمير "علم الدين التنوخي" على كابوسٍ لم يتخيلوه؛ فالعدو الذي توقّعوا قدومه من "أنطلياس" أو "الرويسة" قد انبثق الآن من رحم الأرض، من جهة النهر الذي اعتبروه حارسهم الأبدي. صاح رئيس الفوج بعناصره وهو يرى خيالة المماليك يرصّون صفوفهم بسرعة في السهل: "يا لبسالة الأفرمي! لقد طعن الجبل في خاصرته!".
لم يهدر الجنود التنوخيون وقتاً في الذهول، بل استلوا السيوف وهبّوا كالإعصار من حصونهم للدفاع عن "الميدان"، وعن نابيه، وعن أميرهم وإمارتهم؛ حيث اتخذوا تشكيلات القتال التي يتقنونها جيداً. تحول السهل المنبسط الذي كان مكاناً للعب والفروسية إلى ساحة طحنٍ للدماء. صراخ التحدّي والتهويل راح يعصف في الأرجاء، تتردد أصداؤه المرعبة فتجمّد العقول وتجعل القلوب تضطرب.
كان أحد الخيالة التنوخيين قد امتطى حصانه وتوجّه إلى "بلاطة الغنمة" سالكاً الوادي الشرقي من "الشحّارة" ليطلب الدعم من خيّالة "راميّا". ما هي إلا دقائق حتى سمع المماليك صوت الوغى يهزّ الجبال والوديان من ناحية شمال "الميدان"، بينما كان قد توجّه أحد فرسان راميا إلى قصر الرويسة لإعلام الأمير بما يحصل. لم يكن "الأفرمي" قد توقّع وصول الدعم من راميا؛ لأن الخرائط التي كانت بحوزته لم تُظهر هذا المسلك، وكان يعتقد أن الدعم سيتطلب وقتاً أطول لكي يصل، ظنّاً منه أن الطريق من راميا إلى الميدان هو من الناحية الغربية لتلة الشاوية وليس من الناحية الشرقية.
معركة الميدان
التحم الجيشان في قتالٍ ضارٍ؛ التنوخيون يستميتون لتثبيت أقدامهم في السهل لفتح الطريق أمام القوات القادمة من "راميا"، والمماليك يندفعون بجنون للسيطرة على الميدان. كانت السيوف تبرق تحت شمس تموز الحارقة، وصهيل الخيل يملأ الأفق، بينما يراقب الأفرمي من على صهوة جواده تقدم رجاله، مدركاً أن من يسيطر على "سهل الميدان" يمتلك مفاتيح "نابيه"، ومن يمتلك نابيه فقد روّض الجبل العصيّ.
في تلك اللحظة، أطلّ التنوخي من قمة "الشاوية" بالتزامن مع وصول جنود الرويسة، فصدح صوت البوق عالياً ليشدّ عزائم المقاتلين؛ إذ أدرك الجميع أن الأمير علم الدين التنوخي قد حلّ في ساحة المعركة. في قلب الميدان، اختلط غبار الأرض بدماء الجنود؛ فلم تكن المعركة مجرد صدام عسكري، بل استحالت صراع إرادات بين رجلين يمثل كل منهما عالماً كاملاً. الأفرمي، بجواده الدمشقي الأصيل ودرعه الفولاذي المزركش، يجسد سطوة الدولة المملوكية ونظامها الصارم. أما التنوخي، فكان يقف على أرض الشاوية ثابتاً كأرزة عتيقة، بملابسه الجبلية البسيطة وسيفه العريض الذي ورثه عن أجداده، وعيناه تقدحان شرراً لا ينطفئ.
صاح الأفرمي وهو يوجه جواده نحو خصمه:
"يا علم الدين، لقد جئناك من حيث لم تحسب، فالأرض لله ثم للسلطان، فسلّم تسلم!"
رد التنوخي بابتسامة مرّة وهو يرفع سيفه:
"يا أفرمي، لقد عبرتَ نهراً سميناه نحن 'الموت'، فهل ظننت أن من يعبر الموت يخرج حياً؟ الجبل لا يسلم مفاتيحه إلا لمن يُدفن في ترابه."
دارت في الميدان مجزرة حقيقية؛ جياد تشن هجمات صاعقة، وفرسان يستغلون قوة الاندفاع وطول الرماح. كانت ضربات جيش الأفرمي تمتاز بالدقة المستمدة من تدريبات القلاع، يعتمد أسلوب "الكر والفر" لفتح ثغرات في الصفوف. أما التنوخيون فكانوا يقاتلون بأسلوب الجبل؛ دفاع صلد يتبعه هجوم مباغت كالصاعقة، مستغلين معرفتهم بكل ثغرة وتلة، يضربون بصدق من يدافع عن بيته وعرضه.
تلاحمت السيوف حتى تطاير منها الشرر، وبدا وكأن الزمن قد توقف لمراقبة النزال. ومع انتصاف الظهيرة، بدأت الكفة تميل عددياً لصالح المماليك الذين فاق جيشهم جيش التنوخيين بثلاثة أضعاف. أدرك التنوخي أن الاستمرار على هذا النحو يعني خسارة الحرب، خاصة مع تقدم المماليك نحو سفح الرويسة ومنحدرات الشحّارة، عندها صرخ كبير القادة: "لننسحب إلى الرويسة يا سيدي قبل فوات الأوان!".
تراجعُ الأُسُود
لم يكن قرار الانسحاب سهلاً على نفس الأمير علم الدين، لكنه كان أمراً لا بدّ منه؛ فالخسارة في ساحة الميدان كبيرة، وربما يتمكن من استعادة النصر إذا ما انسحب وتحصّن. أطلق التنوخي إشارة التراجع، فارتفع صوت البوق بنغمة متقطعة وحزينة، ففهم المقاتلون أن الميدان قد ضاق بأهله. بدأ التنوخيون بالانسحاب التكتيكي، حيث شكلوا جداراً من الأجساد والتروس لحماية رفاقهم الجرحى، بينما كانت خيالة المماليك تضغط بكل ثقلها لاستغلال لحظة الانكسار.
تحول السهل إلى فخٍ من الوحل المجبول بالدماء؛ فرسانٌ شجعانٌ من الجيشين ممزقةٌ أجسادهم وممددون بين الوحل والدماء، ذاك المزيج الذي يعطي الأرض رائحة قاسية لا يمكن وصفها أو تعريفها. فالأرض التي كانت ساحةً للفروسية والتمارين والاحتفالات صارت الآن تعيق حركة المنسحبين وكأنها تتشبث بأقدامهم ترفض رحيلهم؛ لا بد أنها تميّز أقدام أصحاب الأرض عن الغزاة.
كان المشهد عند سفح الشاوية مهيباً ومأساوياً؛ الجنود التنوخيون يصعدون المنحدرات وهم يواجهون بصدورهم ضربات الرماح، يقاتلون بضراوة لئلا يتحول الانسحاب إلى هزيمة ساحقة. وفي تلك اللحظة الحرجة، برزت الفرقة الثانية من "خيالة راميّا" التي وصلت لتوّها، فشنت هجوماً انتحارياً على خاصرة جيش الأفرمي، مما أحدث إرباكاً مؤقتاً سمح لبقية قوات التنوخي بالانسحاب خلف الشاوية ونزولاً ناحية الرويسة.
وقف الأمير علم الدين على مدخل الحصن يراقب آخر جنوده وهم يدخلون، ينظر إليهم بألم وحزن ممزوجين بالغضب. مسح دماءً غريبة عن سيفه، ونظر إلى ناحية الشاوية حيث كان جيش الأفرمي يثبّت راياته، وقال بصوتٍ خفيض لم يسمعه إلا صدى الجبل ولم تردّده الوديان:
"لقد أخذتم الميدان والشاوية يا أفرمي، لكن راميّا لا تزال لنا، والرويسة لا تنحني إلا للريح."
أُغلقت البوابات الضخمة، وساد صمتٌ ثقيل، لم يقطعه إلا أنين الجرحى وصوت الريح التي بدأت تهبّ من ناحية "نهر أنطلياس"، محملةً برائحة الغبار والحديد، لتعلن عن بداية ليلٍ طويلٍ من الحصار.
انكسار الرويسة
أطبق الحصارُ فكّيه على حصن الرويسة، واستحالتِ الأيامُ إلى ليلٍ سرمديٍّ من الجوع والترقّب. في الخارج، كان جيش الأفرمي قد نصب المنجنيقات العملاقة التي بدأت تقذف أحجاراً صوانية صمّاء لا تعرف الرحمة تواكبها رشقات الأسهم المشتعلة الرؤوس، ومع كلِّ ضربةٍ، كان الحصنُ يهتزُّ ويترنّح، فتتداعى الحجارةُ وتتشرذمُ الأبراجُ التي صمدت لقرون في وجه الريح.
بدأت جدرانُ القلعةِ بالانهيار، وتصاعدَ غبارُ الحجرِ والترابِ ليغطيَ سماءَ "نابيه"، محوّلاً شمسها إلى قرصٍ باهتٍ وضئيل. كانتِ الصدوع التي بدأت تتفتّق على الأسوارِ تُعلنُ نهايةَ حقبةٍ من الحكم والسلطان وبداية عهد آخر؛ فالحصنُ الذي اعتبره التنوخيون عصيّاً، بدأ يتفتتُ تحت وطأةِ القصفِ المتواصلِ ونيرانِ النفطِ المشتعلة، حتى هدمتِ القذائفُ شرفاته العالية.
في اللحظة التي هوى فيها البرجُ الشماليُّ مُحدثاً دويّاً زلزلَ أركانَ الجبل، كان القرارُ المرُّ قد اتُّخذ. في عتمةِ الممراتِ الداخليةِ التي خنقها الغبار، بدأ الموكبُ الحزينُ في النزولِ الصامت. تقدمَ الأمير علم الدين التنوخي بخطىً مثقلةٍ بمرارة الهزيمة، يتبعهُ أفرادُ عائلتهِ وحاشيته المخلصة الذين كسا الشحوبُ وجوههم بينما كانت فرائص النساء ترتعد وأرجل الرجال تتعثّر، متسللين إلى أعماق "الدهليز" السري الغائر تحت بلاط القاعة الكبرى، حيث تقود الدرجات الحجرية الرطبة إلى قلب الصخر، هناك حيث بٍني هذا الملجئ تحسّباً للأيام الصعبة منذ عشرات السنين، وإذا بهذه الأيام تطرق الباب الآن.
وهناك، قبل أن تُغلق المداخل الصخرية العملاقة للرويسة إلى الأبد، تقدم ساحر الأمير بخطواتٍ غامضة حاملاً بيده مبخرة تنبعث منها رائحة غريبة تسكر العقول، نافثاً تمائمه ومتمتماً بكلماتٍ قديمة، حيث قام بوضع "رصدٍ" منيعٍ يحرس تلك المداخل ويحمي من في الداخل من كيد الغزاة.
نزلوا إلى الكهف المخصص والذي يحتوي جميع كنوز الامير علم الدين التنوخي، فلقد كان وضعها في المكان الأكثر أماناً في رحم الصخر الأصمّ، الباردٍ والمظلم، والذي لا تصله سنابك خيول المماليك ولا صرخات ظفرهم.
صالة صخرية واسعة مليئة بالذهب والأحجار الكريمة، وهي مستودع للطعام وفيها نافورة مياه عذبة من تلك التي تمّ جرّها من عين الماء.
ساد سكونٌ جنائزي جميع الموجودين، ولم يبقَ سوى صدى دويّ انهيار القلعة في الأعلى، ليعلن سقوط الرويسة وغياب .شمس التنوخيين خلف صخور الجبل.
لم يكن ذلك الانهيار نهاية الحكاية فحسب، بل صار شاهداً أبدياً؛ إذ لا تزالُ حجارةُ القلعةِ حتى يومنا هذا متراميةً على حافةِ "الشير" الصخري، صامدةً فوق نهر أنطلياس، تحكي لكل من يمرُّ بها قصة تلك المعركة، وتستذكرُ بصمتٍ مهيبٍ كيف تهاوت الحصون وبقي الجبل، بينما يظل الرصدُ قابعاً هناك، يحرسُ أسرارَ الدهليزِ المفقود.
السرّ المفقود المرصود
لم يكد الأفرمي يستقر في القلعة المهدومة حتى أبلغه جنوده انهم لم يجدوا بين القتلى لا جثة الأمير "علم الدين التنوخي" ولا حتى اي جثة أي شخص من عائلته، فأمر بحملة تفتيش واسعة لم تترك حجراً إلا وقبته.
نزل جند الأفرمي إلى أقبية الحصن المحطمة، وبدأوا بقرع الجدران والبحث عن فجوات مخفية. وجدوا بقايا "الدهليز" السري، لكنهم كلما حاولوا الاقتراب من المدخل الصخري العميق، كانت خيولهم تنفر وتصاب بالذعر، وجنودهم يشعرون بضيق مفاجئ في الصدور وخوف من مجهول؛ فـ "رصد الساحر" كان يعمل بقوة، مانعاً أي غريب من اكتشاف الممر المؤدي إلى الكهف السحيق.
عندما فشل البحث العسكري، لجأ الأفرمي إلى المكر؛ فجمع وجهاء القرى المجاورة من "راميّا" و"الرويسة"، وهددهم بحرق ما تبقى من محاصيلهم إذا لم يفصحوا عن مخابئ التنوخي السرية. كان يعرف أن للتنوخيين "مغاور لجوء" قديمة لا يعرفها إلا أبناء الجبل، لكن الولاء للأمير كان أقوى من الخوف، فصمت الجميع صمتاً أطبق على أنفاس الأفرمي.
استشاط الأفرمي غضباً، وأدرك أن النصر الذي حققه قد يتبخر إذا ظل التنوخي حياً يجمع حوله فلول المقاتلين في الجبال. فأصدر أوامره فوراً: "ارفعوا كل حجر، وانبشوا كل مغارة.. أريد التنوخي حياً أو ميتاً!"
بدأت رحلة البحث، مشّط الجنود " الميدان " نزولاً ناحية " بلاطة الغنمة " و " راميا "، ومن الميدان نزولاً حتى " الرويسة " مروراً بتلّة " نابيه ".
كادت حملة تفشل لولا أنه
وبينما كان أحد فرسان المماليك يتجول في نطاق "عين المياه"، زلّ حافر حصانه على جسم صلب تحت التراب؛ فنزل عن صهوة جواده وتفحصه، فإذا به يكتشف قسطلاً فخارياً قديماً يجر المياه من العين صعوداً نحو الرويسة.
أخبر الفارسُ أميرَ المماليك بما وجد، فأدرك الأفرمي أن هذا هو شريان الحياة الوحيد لمن بقي حياً في أعماق الجبل. أصدر أوامره فوراً بكسر كل قسطل يجدونه، فقطعوا مجاري المياه تماماً، وحكموا على سكان جوف الأرض بالهلاك المحتوم.
انتهت المعركة، ومرّ الزمان، لكن الحكاية بقيت أسطورة يتناقلها أبناء نابيه . ويُفترض أن الأمير التنوخي وعائلته وحاشيته قد قضوا عطشاً في ذلك الدهليز المظلم، بعيداً عن أعين البشر. وحتى يومنا هذا، لا تزال حجارة القاعة مترامية على حافة "الشير" فوق نهر أنطلياس، ولا أحد يعرف مكان "الكهف السحيق" أو كنوز التنوخيين التي لا تزال محمية بـ "رصد الساحر"، مخبأةً في صمت تلة الرويسة التي لا تبوح بأسرارها لأحد.




















