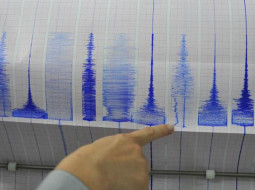يعاني تعليم القانون الدولي في العديد من كليات الحقوق من انحراف خطير عن جوهره المعياري في المنهج والمقاربة، إذ بات يُقدَّم للطلاب بوصفه توصيفاً لعلاقات القوة والمصالح، بدل تقديمه كنظام قانوني قائم على قواعد ومبادئ. يعتمد بعض أساتذة المادة على تفسيرات محض سياسية واقعية، فيشرحون العلاقات الدولية باعتبارها محكومة بموازين القوّة والمصالح المادية والاستراتيجيات. هذا التحوّل من تعليم قانوني معياري إلى تعليم تبريري واقعي، يجعل من القانون الدولي مادة بلا وظيفة، يحوّله إلى مجرد تحسّرٍ نظري على الانتهاكات بدل الدفاع عن فلسفته، ومناصرة جوهره في توطيد السلم والأمن الدوليَّين، والمصالح المشروعة، وفي تقنين العلاقات بين الدول، وإخضاعها لمنطق الشرعية والعدل. حتى لو قامت العلاقات بين الدول على أساس المصالح، فإنّ معيار الشرعية يستدعي التمييز بين المصالح المشروعة وغير المشروعة!
أدّى هذا التحوّل إلى جعل تعليم القانون الدولي تعليماً ترويجياً، يسوّق الانتهاكات بدل أن يفضحها، ويحوّل القانون إلى خطاب بكائي على أطلال نظام ظاهره منهار بدل أن يكون أداة للدفاع عن النظام الدولي وشرعة الأمم المتحدة.
بلغ هذا الإنحراف حداً دفع بعض عمداء كليات الحقوق إلى الاعتذار من طلابهم، لأنّهم درّسوهم نظريات لم يجدوا لها تطبيقاً في الواقع، بل أعلن بعضهم عزوفه عن تدريس القانون الدولي بذريعة انتهاكه من قِبل إسرائيل أو غيرها. لو طُبّق هذا المنطق على القانون الداخلي، لوجب إلغاء تدريس إختصاص الحقوق برمّته، لأنّ القوانين تُنتهك يومياً داخل الدول. الإعتذار عن تدريس القانون الدولي بحجة عدم احترامه، يشكّل استسلاماً للفوضى وعدم احترام المعايير، ويقوّض الأساس الفلسفي للنظام الدولي.
إنّ القول إنّ العلاقات الدولية تُحكم فقط بموازين قوى، يعني عملياً نزع الصفة الحقوقية عنها. لو صحّ هذا المنطق، لما كان هناك فرق بين النظام الدولي وحالة الطبيعة التي تحدّث عنها هوبز State of Nature، وهي الحالة التي تسبق قيام الدولة والقانون، وتكون فيها العلاقات محكومة بالقوّة لا بالقانون. غير أنّ نشوء شرعة الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية شكّل إعلاناً تاريخياً بأنّ السلم لا يقوم على القوّة بل على العدل، وأنّ السيادة ليست امتيازاً مطلقاً، بل وظيفة قانونية خاضعة لضوابط في العلاقات بين الدول.
تُظهر القواعد المشتركة بين القانون الدولي والقانون الداخلي وحدة أخلاقية وحقوقية بين النظامَين. مبدأ احترام الحقوق الأساسية للإنسان، وعدم التعسف في استعمال الحق، وحسن النية، والمسؤولية عن الفعل غير المشروع، والمساواة أمام القانون، كلّها قواعد تحكم علاقة الأفراد بالدولة كما تحكم علاقة الدول ببعضها البعض. تُثبت هذه الوحدة أنّ القانون الدولي ليس غريباً عن البنية القانونية الوطنية، بل امتداد لها على مستوى الجماعة الدولية.
كما يمكن تصنيف العلاقات بين الدول إلى أنماط تؤثر مباشرة في مفهوم السيادة. العلاقات التعاونية الرسمية التي تمرّ عبر القنوات الديبلوماسية والمؤسسات الدستورية تعزّز السيادة ولا تنتقص منها. أمّا العلاقات التي تقيمها فئات داخل الدولة مع أطراف خارجية خارج إطار السلطة الشرعية، سواء لأغراض مالية أو عسكرية أو تفاوضية أو لنشر الفوضى داخل المجتمع أو في مجتمعات أخرى، فإنّها تشكّل تدخّلاً في الشؤون الداخلية ومسّاً بالسيادة (Ingérence).
تبقى مساعدات الدول مشروعة ما دامت تمرّ عبر الدولة المركزية، كما أنّ القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن تهدف إلى حماية سيادة الدول وتنظيم العلاقات بينها لا إلى نزعها. والامتثال لها، كالتفتيش الدولي للتحقق من احترام الدولة لالتزاماتها الدولية في مجالات عسكرية ونووية وإنسانية وبيئية... أو نشر قوات حفظ السلام، لا يعني انتقاص السيادة، بل ممارسة لها ضمن النظام الدولي.
أمّا العلاقات الثقافية والاجتماعية والدينية، كالتبادل الجامعي أو الحج أو الزيارات ذات الطابع الإنساني أو نشاط المنظمات الدولية غير الحكومية والمجتمع المدني، فهي خارج نطاق العلاقات الدولية الرسمية والديبلوماسية، ولا يجوز إخضاعها لمنطق التخوين أو الاشتباه السياسي، لأنّ الخلط بينها وبين العلاقات السيادية يعكس جهلاً بالمفاهيم الحقوقية الأساسية.
شهد النظام الدولي خروقات فاضحة لمبادئ الشرعية الدولية، أبرزها غزو العراق سنة 2003 خارج إطار الأمم المتحدة. غير أنّ هذه الانتهاكات لا تُبطل القاعدة بل تؤكّد ضرورتها. جميع التجارب التاريخية التي قامت على القوّة المجرّدة، من نابوليون إلى نازية هتلر وفاشية موسوليني، وصولاً إلى أنظمة الاستبداد الحديثة كحكم الأسد وصدام والقذافي، انهارت لأنّها افتقرت إلى الشرعية. تحتاج القوّة إلى قانون لتتحوّل إلى سلطة مشروعة، وإلّا تبقى إكراهاً بلا سند قانوني.
إنّ أزمة القانون الدولي الحالية ليست أزمة نصوص بل أزمة تفكير وتدريس وتطبيق. يكمن الخلل في الخلط بين Lex (القانون المكتوب)، وJus (الحق والعدل)، وNormes (المعايير السلوكية). القانون الدولي ليس مجرّد اتفاقات، بل منظومة قيم ملزمة، في مقدّمتها تحريم استخدام القوة، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، وعدم التدخّل في الشؤون الداخلية، والمساواة في السيادة بين الدول، وحق الشعوب في تقرير مصيرها.
لا يحتاج العالم إلى استبدال الأمم المتحدة بمنظمة أخرى، لأنّ قيام نظام دولي بديل يفترض صدمة كونية كبرى أو حرباً عالمية ثالثة، وفترة زمنية قد تمتد سنوات وعقود لإيجاد شرعات جديدة. ومَن يضمن عدم خرقها من دول مارقة؟ المطلوب هو إصلاح المنظومة من الداخل، وإعادة الاعتبار إلى وظيفتها الأخلاقية، وخلق نخب ديبلوماسية وقانونية تتحمّل مسؤوليّتها الإنسانية، لا موظفين يكتفون بتنفيذ التعليمات وتحصيل الرواتب.
كل الأطروحات التي عالجت القانون الدولي ومنظمة الأمم المتحدة خلصت إلى اقتراح تعديل شرعة الأمم المتحدة. إنّ إصلاح الأمم المتحدة يبدأ من إصلاح طريقة تعليم القانون الدولي وامتثال الحكّام لقواعد القانون الدولي. يؤدّي التلوّث في المصطلحات إلى تلوّث في المواقف، والتشكيك في القواعد يؤدّي إلى تبرير الانتهاك.
إذا جُرّد القانون الدولي من روحه المعيارية، يفقِد وظيفته التاريخية في منع عودة البربرية إلى العالم. يبدأ انهيار القانون في النفوس ومن قاعات الجامعات، قبل أن يظهر في ساحات الحروب. السلم لا يصنعه ميزان القوى، بل ميزان العدالة.