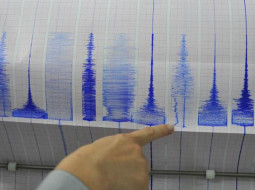تراجعت مشاعر القلق التي كانت سائدة بين اللبنانيِّين إثر التهديدات الإسرائيلية والتحذيرات الأميركية والأوروبية وحتى المصرية، من قيام الجيش الإسرائيلي بشن حرب «جراحية» على مواقع محدّدة في لبنان، تطال الأسلحة الثقيلة لـ»حزب الله» ومصانع تركيب الصواريخ والمسيّرات وتوسيع المنطقة المنزوعة من السلاح حتى حدود الأولي، أي بضمّ مخيّم عين الحلوة إليها. وتبدّدت الأجواء السلبية، إثر إعلان لبنان تعيين السفير سيمون كرم رئيساً للجانب اللبناني المشارك في اجتماعات «الميكانيزم». لكنّ الأوساط الدولية تؤكّد أنّ هذه الإنفراجة موقتة، وقد تنتهي مع مطلع العام المقبل.
فرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الذي يعيش واقعاً داخلياً مأزوماً قد ينعكس سلباً على حظوظه الإنتخابية، أعلن في أكثر من مناسبة بأنّ الهدف الحقيقي الذي يسعى إليه هو نزع سلاح «حزب الله»، وأنّه في حال لم تُنفِّذ السلطة اللبنانية هذا الأمر مع نهاية العام، فستعمد إسرائيل على تنفيذ ذلك بنفسها. وليس سراً أنّ واشنطن تؤيّد موقف نتنياهو، ولو أنّ ترامب طلب منه وبشكل علني تغليب اللغة الديبلوماسية على الحربية في المرحلة الراهنة، وذلك إثر تعيين لبنان للسفير سيمون كرم في «الميكانيزم».
لكن ثمة تناقضاً واضحاً بين المفهومَين اللبناني والإسرائيلي للمشاركة المدنية في «الميكانيزم». فلبنان يُريد دفع إسرائيل لتنفيذ اتفاق وقف النار، لناحية انسحابها من النقاط الخمس وإطلاق سراح الأسرى ووقف الإعتداءات الجوية. لكن لإسرائيل مفهوماً آخر، أشار إليه نتنياهو غداة القرار اللبناني، عندما تحدّث عن تفاهمات إقتصادية. ومن المنطقي الإستنتاج بأنّ أي تفاهم إقتصادي لا بُدّ أن يسبقه تفاهم سياسي. وباختصار، فإنّ الطموح الإسرائيلي لا يتطابق مع الواقعية اللبنانية، وهو أكبر بكثير من قدرة لبنان على تحمّله.
الموفدون الذين يزورون لبنان، وكان آخرهم الفرنسي جان إيف لودريان، باتوا يعربون عن تفاؤلهم بتحقيق تقدّم ثمين، على الأقل في مسألة تكريس المنطقة العازلة. لكنّ المشكلة هنا أيضاً في كيفية تفسير هذه المنطقة. فالجانب الإسرائيلي يُريدها خالية بالكامل من السكان، وواشنطن تعتقد أنّ جعلها منطقة إقتصادية ممكن أن يُشكّل مخرجاً مناسباً لها. أمّا التفسير اللبناني، فهو بأن تكون المنطقة خالية بالكامل من السلاح لا السكان، وأنّ لا أحد في لبنان قادر على مجرّد مناقشة هذه المسألة.
في أي حال، فإنّ لبنان ما زال ينتظر الدعم الدولي المنشود لتأمين الدعم للجيش ولتأمين أموال إعادة الإعمار. وفي وقت تربط فيه الدول المانحة ملف إعادة الإعمار بنزع سلاح «حزب الله»، فإنّ ملف تأمين الدعم للجيش اللبناني شهد خطوة مهمّة، مع التحضيرات الجارية لعقد اجتماع رباعي في باريس في 18 الجاري بين ممثلين عن فرنسا والولايات المتحدة والسعودية، بالإضافة إلى قائد الجيش اللبناني، للتمهيد لانعقاد مؤتمر دعم الجيش مطلع العام المقبل في فرنسا.
ويبدو لبنان حذراً في تفاؤله، خصوصاً مع تأكيد فرنسا والسعودية مشاركتهما، لكنّ المندوبة الأميركية مورغان أورتاغوس كانت ولغاية مساء أمس لم تؤكّد مشاركتها بعد، على رغم من التأكيدات الفرنسية بأنّ القرار الأميركي هو بالمشاركة، وأنّ إعلان ذلك قد يتأخّر حتى مطلع الأسبوع المقبل. ذلك أنّه في حال عدم المشاركة الأميركية فإنّ الإجتماع سيفقد معناه، وسيصبح إنعقاد مؤتمر دعم الجيش في مهبّ الريح. والجيش اللبناني يعمل على تجهيز خطواته لإعلانه إنجاز المرحلة الأولى التي أعلنها، وتتضمّن جعل منطقة جنوب الليطاني منزوعة السلاح قبل نهاية السنة.
لكن ثمة نقطتَين ستعمد إسرائيل إلى إثارتهما للقول بأنّ لبنان لم يُنفِّذ إلتزاماته. النقطة الأولى وتتعلّق بما أثارته إسرائيل في الفترة الأخيرة لناحية وجوب تفتيش المنازل بحجّة تخزين أسلحة بداخلها ووجود مداخل أنفاق في بعضها الآخر، وهو ما يرفض الجيش القيام به لتعارضه مع القوانين اللبنانية. والنقطة الثانية وتتعلّق بالسلاح الموجود داخل المخيّمات الفلسطينية، وتحديداً في مخيمَي الرشيدية وعين الحلوة. فالخطوة التي تولّتها السلطة الفلسطينية بتسليم السلاح الثقيل الذي بحوزتها، لم يدفع بحركة «حماس» والفصائل التي تدور في فلكها لتسليم سلاحها، على رغم من الوعود التي أغدقتها قيادة «حماس» في لبنان على السفير الفلسطيني في بيروت.
في هذا الوقت، كان الجيش اللبناني يعمل على إحكام قبضته على كامل محيط المخيمات الفلسطينية في لبنان، ومن بينها مخيّما الرشيدية وعين الحلوة. وبدا واضحا أنّ إنهاء هذا الملف قد لا يحصل من دون قرار بدخول الجيش عسكرياً إلى قلب المخيّمَين. لكن هنالك محاذير كثيرة في حال اتخاذ هذه الخطوة، وهو ما يجعل حركة «حماس» والفصائل الإسلامية تتمنّع عن تسليم سلاحها عبر المفاوضات. وجاءت خطوة مقاطعة الفصائل الفلسطينية لحفل الإستقبال الذي أقامته السفارة الفلسطينية في مناسبة العيد الوطني الفلسطيني، لتعطي الإنطباع بأنّ هذه الفصائل اتخذت قرارها بعدم التعاون.
ووفق ما تقدّم، تعتقد الأوساط المراقبة بأنّ إسرائيل ستستعيد لغة التلويح بعملية عسكرية «جراحية» مع انطلاق العام الجديد، خصوصاً أنّ نتنياهو الذي يعاني من تصاعد مستوى الهجمات عليه، سيجد كلّما تقدّم الوقت، ظرفاً ملائماً للإمساك بأوراق رابحة، تساعده في استمالة الشارع الإسرائيلي في الحملات الإنتخابية. ويبدو أنّ نتنياهو يراهن على مفاجآت عسكرية ستساعده في تحقيق أهدافه العسكرية الجديدة. وخلال العام المنصرم حصلت تبدُّلات مذهلة ما كان أحد يتصوّرها، وجاءت نتيجة الحروب التي شنّتها إسرائيل. وأحد أبرز هذه المتغيّرات كانت بسقوط نظام بشار الأسد ووصول أحمد الشرع ومجموعته المصنّفة كتنظيم متطرّف. لكنّ المفاجأة كانت بأنّ هذه المجموعة لم تكتفِ بتحقيق تحالف وثيق مع الأميركيِّين بل ذهبت، ووفق مسار سريع، بالبدء بمفاوضات مباشرة مع إسرائيل على طريق إنجاز تسوية سلمية بينهما. وكَثُر الكلام في الكواليس حول وجود نوع من أنواع التنسيق الأمني بين دمشق وتل أبيب، لكن عبر واشنطن. فالمخابرات المركزية الأميركية CIA، كما الجيش الأميركي، عبر قيادة المنطقة الوسطى، هما على تنسيق في العمق مع الجيش السوري والأجهزة الأمنية.
وبعد عودة الشرع من زيارته المثيرة إلى البيت الأبيض، ساد حديث عن تفاهم أميركي كامل مع دمشق، وكان للشرع تصريح تحدّث فيه عن أعداء سوريا مثل «داعش» والحرس الثوري الإيراني و«حزب الله». ولذلك، كان من البديهي أن تُطرَح العديد من الأسئلة حول ما إذا كانت دمشق ستعمد إلى ملاقاة إسرائيل عند قيامها بضرب «حزب الله» مرّة جديدة، خصوصاً أنّ البقاع الشمالي يمتاز بمسافة حدودية طويلة مع سوريا، وكان يُشكِّل الممر العسكري الأساسي لـ«حزب الله» باتجاه سوريا وصولاً إلى إيران. كما أنّه مجاوِر لمحافظة حمص، حيث الحضور العلوي الممتد حتى الساحل السوري.
أمّا أسباب هذا العرض، فتعود للتحرّك المُريب الذي قام به السوريون في لبنان في الذكرى السنوية الأولى لسقوط نظام الأسد. فما حصل شكّل مفاجأة صادمة للدولة ولمختلف الفئات اللبنانية بمَن فيهم «حزب الله». وهنا تسارعت الأسئلة حول حقيقة هذه التحرّكات والرسائل التي تحملها في حال كانت مقصودة.
في الملاحظة الأولى، إنّ هذه التحرّكات حصلت في مناطق مختلفة، لكن بشكل منسّق ومتزامن. وكأنّ هنالك قيادة واحدة تولّت تحريك هذه «التظاهرات».
وفي الملاحظة الثانية، إنّ حوالى 70% من المشاركين كانوا من السوريِّين.
أمّا الملاحظة الثالثة، فتتعلّق بالمناطق التي شملتها التظاهرات، وهي حساسة مثل خلدة، كونها تؤدّي إلى قطع الطريق الساحلي لتواصل «حزب الله» بين الضاحية والجنوب، وأخرى دقيقة كونها لامست مناطق البيئة الحاضنة لـ»حزب الله» مثل الضاحية وحارة صيدا.
والملاحظة الرابعة، إنّ بعض المشاركين حملوا مسدّسات وعمدوا إلى إطلاق النار منها.
ومن هنا طرح الأسئلة حول ما إذا كان هنالك من رسائل تطال «حزب الله»، أم أنّ ما حصل له أبعاد أخرى غير سياسية؟ ذلك أنّ بعض الأوساط المراقبة قرأت في التحرّك الذي حصل رسائل واضحة تقول لـ«حزب الله» بأنّ هنالك مجموعات قادرة على التحرّك حتى ولو احتاج ذلك إلى استخدام القوّة، وهو ما يمكن استنتاجه من ظهور المسدّسات.
وسُجِّل للجيش تحرُّكه السريع لمنع حصول صدامات وتفاقم الأوضاع، وأعطى الأوامر بالتصرُّف بحزم ومن دون أي تهاون. وعمد في اليوم التالي إلى تنفيذ ليل أمني في المناطق التي شهدت التحرُّكات، فجرى توقيف العديد من الأشخاص الذين لا يحملون أوراقاً قانونية، بالإضافة إلى تُهَم قانونية أخرى.
لكنّ قيادة «حزب الله» بدت وكأنّها ليست متأكّدة من أنّ ما حصل كان هدفه توجيه رسائل لها. فالمناخ السياسي الذي تعيش فيه مختلف، وهو ما يجعلها تضع فرضية أخرى تتعلّق بالنفوس المشحونة والتحرّكات الفورية، أو ربما وجود اختراقات أو تفلّت لمجموعات قاتلت مع التركيبة التي أمسكت بالقرار في دمشق، لكنّها بقِيَت خارج السلطة. وما يُعزّز قراءتها هذه، وجود تواصل ميداني تحكمه طبيعة الأرض والحدود في بعض الأحيان، وأنّ هذا التواصل يتخلّله بعض التعاون ولو ضمن حدود معينة.
كذلك، فإنّ وفد «حزب الله» الذي زار تركيا، سمع وجود رغبة قوية بفتح باب التواصل والتفاهم مع دمشق، لا بل مساعدة السلطات السورية في العديد من الجوانب. وإنّه لا يمكن أن تكون هنالك رسائل ميدانية من هذا النوع، في وقت تكون هنالك طلبات أخرى على المستوى الأعلى. وهنا قد تبرز لدى قيادة «حزب الله» إمكانية وجود خرق خارجي إذا كان لا بُدّ من وضع ما حصل في إطار الرسائل الملغومة، أو ربما في إطار الخلافات المتفلتة بين مختلف التنظيمات السورية.
وقد تكون نتائج الإستطلاعات التي خرجت بها مؤسسة الـ«باروميتر» العربي، ونشرتها مجلة الـ«فورين أفيرز»، تُعطي صورة أوضح عن الواقع الداخلي السوري المنقسم. أساساً كان ذلك قد برز بوضوح مع كيفية مشاركة المناطق السورية مع احتفالات ذكرى سقوط النظام. فمدينة السويداء بقِيَت خارج هذه الإحتفالات، على رغم من أنّها كانت من المناطق الأساسية التي ساهمت في إسقاط الأسد. والساحل السوري نفّذ إضراباً شاملاً ضدّ السلطة. كما أنّ مناطق «قسد» لم تحتفل.
وفي الإستطلاع، إنّ الثقة بالرئيس السوري في السويداء واللاذقية وطرطوس كانت 36% وبالحكومة 36% أيضاً، وبالجيش 22%. أمّا على المستوى الوطني، فإنّ الثقة بالشرع بلغت 81% وبالحكومة 71% وبالجيش 71%. واعتبر 76% منهم أنّ سياسة الشرع أفضل من سياسة الأسد. وفي السويداء واللاذقية وطرطوس أيّدت نسبة 31% وجود حرّية تعبير، و34% وجود حرّية صحافة، و16% وجود حرّية تجمّع، و35% فقط بأنّ الحكومة تُلبِّي إحتياجاتهم، في مقابل 67% على المستوى الوطني.
لكنّ اللافت كان حول الشركاء المفضّلين، إذ حلّت السعودية في المرتبة الأولى مع نسبة 87%، ثم قطر 83%، فتركيا التي حلّت ثالثةً مع 73% والإتحاد الأوروبي 70% فواشنطن 66%. أمّا إيران فحازت على 5% فقط، وروسيا فنالت 16%، وإسرائيل 4%، أمّا الصين فنالت 37%.
لكن، وبغضّ النظر عن كل هذه التعقيدات والخيوط المتشابكة ولعبة الخداع التي قد تلجأ إليها العديد من الدول، فإنّ الأنظار تتّجه فعلياً باتجاه واشنطن التي باتت تستأثر بوجهة الحركة في المنطقة. ففي وقت كان فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدشّن أول التجمّعات الإنتخابية من ولاية بنسلفانيا للإنتخابات النصفية، كان الحزب الجمهوري يتلقّى صفعة إنتخابية جديدة شكّلت ما يشبه الصدمة، إذ خسر منصب العمدة لمدينة ميامي، في مقابل فوز المرشحة الديمقراطية للمرّة الأولى منذ 28 عاماً، وبفارق كبير. إذ فاز الديمقراطيّون بنسبة 59,4% مقابل 40,5%.
صحيحٌ أنّه لا يمكن الحُكم على نتائج الإنتخابات النصفية من خلال هذه النتيجة فقط، لكن لا بُدّ من الملاحظة بأنّ معظم المواجهات الإنتخابية التي حصلت خلال الأسابيع المنصرمة بدءاً من نيويورك، وجّهت صفعات متتالية، ليس فقط للحزب الجمهوري، لكن لترامب تحديداً، ممّا يجعله بحاجة لاستمالة القاعد الشعبية من خلال إنجازات إقتصادية أولاً، والأخطر مراعاة اللوبي اليهودي المؤثر والنافذ، الذي وقف ضدّه في نيويورك.