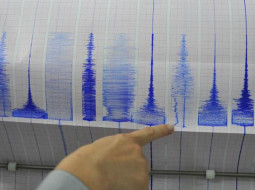تتردّد اليوم في بعض الأوساط اللبنانية، السياسية والشعبية، فكرة خطيرة مفادها أنّ «الهزيمة أمام إسرائيل أفضل من التنازل للدولة». كأنّ بعض اللبنانيِّين، في خِضَم التحوّلات المتسارعة في المنطقة، يُفضّلون انهياراً وطنياً كاملاً على الإعتراف بسلطة الدولة الواحدة وشرعيّتها. هذه المفارقة، سبق أن حذّر منها الصحافي نجم الهاشم، والدكتور أنطوان مسرّه، وهي ليست جديدة على التجربة اللبنانية. إنّها تُعيدنا إلى مأساة 13 تشرين الأول 1990، حين اختيرت المواجهة الخاسرة على الانضمام إلى الدولة، فكانت النتيجة كارثة وطنية ما زالت آثارها قائمة حتى الوقت الراهن.
يومها، رفضت حكومة العسكريِّين الانضمام إلى السلطة الشرعية المنبثقة عن ميثاق الطائف، وكانت تحظى بحالة تعاطف شعبي مسيحي، معتبرةً أنّ الاتفاق ينتقص من السيادة. لكنّ رفض الانضمام، باسم السيادة، قاد إلى نقيضهما: استُعين بالجيش السوري لإنهاء حالة التمرّد، ودخلت القوات السورية للمرّة الأولى في تاريخ لبنان الحديث القصر الجمهوري في بعبدا ووزارة الدفاع في اليرزة، ونُقِلت ملفات رسمية بكاملها إلى دمشق، واعتُقل ضباط لبنانيّون كبار وسُجِن بعضهم في سوريا، فيما استشهد نحو 170 ضابطاً وجندياً وفُقِدَ آخرون لم يُعرَف مصيرهم بَعد، واستقال حوالى 500 ضابط. ثم رفضت حكومة الرئيس عمر كرامي محاولات البعض بالرجوع عن استقالتهم. كانت كلفة التمرّد فادحة على الدولة.
النتيجة كانت واضحة: الاستعانة بجيش غريب لاستعادة شرعية الدولة، أدّت إلى وصاية شاملة امتدّت 15 عاماً، وخسارة مزدوجة للدولة: سيادية ومؤسساتية. لم تكن الهزيمة حالة فردية أو محصورة بحالة التمرّد وقيادتها، بل شكّلت هزيمة للدولة نفسها التي اضطُرّت إلى المساومة لاستعادة رمزَين سياديَّين لم تطأهما أي قوّة أجنبية من قَبل. ومع ذلك، استطاعت المؤسسة العسكرية لاحقاً، أن تُعيد بناء نفسها على قاعدة «لا غالب ولا مغلوب»، وأن تمتصّ الإحباط المسيحي الكبير عبر إعادة دمج الألوية وتوحيدها، فاستعاد الجيش دوره الوطني الجامع، وأصبح في التسعينات عنواناً لوحدة البلاد ومناعة شبابها.
اليوم، يلوح في الأفق خطر تكرار تلك التجربة بصورة معكوسة: هذه المرّة ليست مارونية سياسية ترفض الانضمام إلى الدولة، بل «شيعية سياسية» (لا نعني الموارنة ولا الشيعة عموماً) قد تُفضِّل الهزيمة أمام إسرائيل على الاندماج في الدولة اللبنانية، والكلفة هنا بالغة الخطورة.
في الحالتَين، المرض واحد: رفض الانضمام إلى الدولة إذلالاً أو تنازلاً، بدل النظر إليه كمشاركة في الكيان المشترك. إنّها، بتعبير أنطوان مسرّه، «حالة مرضية في علم النفس العيادي السياسي»، تتجلّى في فقدان المناعة الوطنية، وفي التكرار اللاواعي للمغامرة نفسها باسم الكبرياء.
لكنّ التاريخ يُعلّمنا أنّ فضيلة الحذر Prudence، التي شدّد عليها سقراط في فلسفته الداعية إلى التفكّر والنقد الذاتي والتبصّر وربطها بالمصلحة العامة (وقوله إنّ الحياة التي لم تُفحص لا تستحق أن تُعاش)، هي في جوهرها أعلى درجات الشجاعة السياسية. الحذر ليس خوفاً ولا ضعفاً، بل إدراك للحدود بين الممكن والمستحيل، وبين الخسارة الجزئية والخسارة الكاملة. فالإقرار بالخسارة في لحظة ما، إذا كان يحفظ الكيان والدولة، ليس هزيمة بل إنقاذ. الحذر، هنا، هو التنازل ليس لمصلحة فئة، بل لصالح الوطن.
إنّ تجنّب صدام مباشر في زمن تهديدات إسرائيلية معلنة، لا يعني الخضوع، بل يعني إدارة الخسارة بحِكمة لتفادي خسارة أعظم. لبنان، كما أظهر التاريخ، لا يحتمل هزيمة تُصيب طائفة أساسية فيه من دون أن تهتزّ أركان الدولة كلّها. وإذا ما شعرت طائفة شيعية بأنّها «مغلوبة»، فإنّ آثار ذلك النفسية والسياسية قد تمتد لعقود، كما حصل مع المسيحيِّين بعد 13 تشرين. وحده الحذر، بمعناه السقراطي، يمنع هذا التكرار ويحول دون تفكك جديد في النسيج الوطني.
الحذر هو الاعتراف بأنّ المصلحة العامة فوق المصلحة الفئوية، وأنّ الانضمام إلى الدولة شرط لبقاء أي جماعة داخلها. وهو فضيلة نادرة في السياسة اللبنانية التي يغلب عليها الإندفاع العاطفي والغريزة والإنكار. إنّ الدفاع عن السلاح، أياً كان مبرِّره، لا يمكن أن يكون مبرِّراً لتقويض الدولة. كما أنّ المطالبة بجيش واحد ودبلوماسية واحدة لا ينبغي أن تكون دعوة إلى الإنتقام أو الإلغاء. المطلوب مقاربة وطنية تحفظ الجميع وتمنع الجميع من السقوط في فخ الهزيمة أو الانتحار المغلّف بشعارات تُدمّر الوطن.
الانضمام إلى الدولة لا يعني الاستسلام، بل المشاركة في القرار الوطني. والدولة اللبنانية أثبتت بعد كل انهيار قدرتها على النهوض بفضل مؤسساتها، وعلى رأسها الجيش اللبناني الذي أعاد بناء ذاته كمؤسسة جامعة. ولعلّ استلهام هذا النموذج هو المدخل اليوم إلى مخرج آمن: نزع السلاح بقناعة ذاتية، لا بالقهر، وتثبيت مرجعية الدولة بالتدرّج لا بالعنف، تماماً كما جرى في مراحل سابقة.
في زمن الضغوط الإقليمية والتهديدات الخارجية، يحتاج لبنان إلى حذر سقراطي أكثر من حاجته إلى سجالات كلامية. فليس الخطر في خسارة معركة، بل في أن تخسر الدولة مرّة جديدة فرصة خلاصية. الحذر فضيلة سياسية، لا تواطؤاً ولا ضعفاً، بل طريق لتجنّب تكرار 13 تشرين آخر، حفاظاً على وطن لا يحتمل اجتياحاً جديداً، ولا مزيداً من الخسائر.