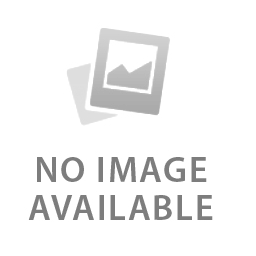

25 عاماً على رحيل شاكر أبو سليمان، الرجل الذي ربطتني به صداقة نقية مادتها الوفاء. في هذه المناسبة، تركت ليراعتي أن تخطّ هذه الكلمة - التحية. على تواضعه ودماثته كان يطرب لكلمة «بريزيدان»، عندما كان يبادره بها أصدقاؤه الكثر وعارفوه.
هذا المتيني الوافد من متن المتن، وفي زرقة عينيه تتهادى أشرعة الذكاء، وعلى جبينه شمخة صنّينيّة، وعلى لسانه تتدفّق بلاغة آسرة: حمماً ساعة الموقف، ونسائم حيية في حضرة الخلان، لم يكن يوماً صفراً على رصيف الحياة الوطنية والسياسية، بل كان واحداً من الرجال الذين آمنوا بوطن الأرز قيمة حضارية مطلقة، تنطوي على غنى الإنسانية النوعي، ورسالة تتجاوز نطاقه الجغرافي، لما يُمثل من أبعاد مسكونية فرضت إيقاعها على هويّته الجامعة للأديان السماوية تستظله، وتتفاعل على أرضه. وكان يرى في هذا اللبنان الذي انساب في مسامه، ولبسه كمسوح الراهب المتعبّد لربّه، النموذج الفريد الذي يستحق الدفاع عنه. وهو آمن بأنّ مسيحيّته بوابته على الآخر المختلف، وأنّ كنيسته المارونية الإنطاكية التي انبعثت في هذا الشرق ومنه، هي كنيسة فداء ورجاء، خيمتها الحرّية والثبات في الأرض. لذا انخرط في خدمتها ذائداً عنها في أزمنة الشدائد والاستحقاقات الصعبة، مقتفّياً خطى الماهدين الذين لم يبخلوا بالدم والدمع والعرق، لتبقى راية الحرّية خفاقة، تطوي عاديات الزمن من دون أن تفلح هذه في طيّها، لأنّها من نسيج الشهادة التي لا يخبو نارها ونورها على كرّ الأيام. ومن هنا، اتسمّ دوره على رأس الرابطة المارونية: رجلاً في مؤسسة ومؤسسة في رجل.
ويضيق بنا المجال في تبيان ما كان لشاكر أبو سليمان من حضور في نادي الكبار يصدقهم القول، ويصارحهم من دون أن يخشى في الحق لومة لائم. كان ضميراً مارونياً حياً تنبض فيه النخوة، وتتّقد روح المبادرة، مدافعاً عن مارونيّته لا من منطلق طائفي ومذهبي، بل من مشارف إيمانه العميق بأنّ دفاعه هو في سبيل لبنان الواحد في تنوّعه، والمتنوّع في وحدته، والذي تُشكّل فيه التعدّدية مصدر ثراء إنساني لم يؤتَ لأي بلد. وكأنّ لسان حاله يردّد مع شارل قرم صاحب «الجبل الملهم»: «لم أرَ وطناً بهذا الحجم، ولا قدراً بهذا الاتساع». وانطلاقاً من إيمانه بلبنان الواحد، كان مهجوساً بوحدة المسيحيِّين في لبنان، بدءاً من وحدة الموارنة لأنّهم ملح هذا الوطن، ونذر جهده لهذه الغاية النبيلة، ولم يبخل بتضحية، ومَن منا لا يذكر كيف تصدّى بشجاعة لامست التهوّر لتلك المذبحة الكبرى التي جرت وقوعاتها في المناطق المسيحية التي أطلق عليها اتفاقاً في حينه «المناطق المحرّرة»، والتي مثلت فصولها بين فريقَين كان يفترض أن يكونا في خندق واحد، فلم يرحم الأخ أخيه، والجار جاره، وانفلتت الأحقاد من عقالها، ما حدا بالمثلث الرحمات الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير أن يصفها، والألم يعتصر منه الفؤاد: «هي حرب الأخوة الأعداء».
وحده كان شاكر أبو سليمان والأباتي بولس نعمان مع حفنة من الأبطال المغامرين، يتنقلون بين «الشرقيّتَين» على متن زورق، لوقف حمّام الدم المتدفّق غزيراً وظلماً، من شباب قرّروا أن يُحرّروا مناطقهم منهم، بعدما نجحوا في تحريرها من الذين أمعنوا فيها قتلاً وخراباً. كان صوتاً صارخاً وسط صخب المَوج الذي كان يتقاذف زورقه، وبين دويّ المدافع ترسل حممها في كل اتجاه، اللهم إلّا الاتجاه الذي كان يفترض أن تُرسل إليه. لم يترك وسيلة سياسية لم يلجأ إليها من أجل تذكير المتقاتلين المسيحيِّين بمسيحيّتهم، التي تأبى عليهم ارتكاب ما ارتكبوه.
أبا كميل ينطبق عليه قول المتنبّي: «الرأي قبل شجاعة الشجعان/ هو أول وهي المكان الثاني/ فإذا اجتمعا لنفس حرّة/ بلغت من العلياء خير مكان». أجل لقد جمع شجاعة الرأي إلى شجاعة القلب، وقال كلمته ولم يمش بل حاول وحاول وحاول، وإذا قام اليوم من بيننا من يقول: «الدم الماروني خط أحمر»، فإنّ الفضل في ذلك يعود إلى الأمثولة - العظة التي تهادت إلينا من هذا الكبير الذي نحيّي ذكرى ربع قرن على رحيله وكأنّه اليوم في عمر الزمن. وإذا أردنا أن نُعدّد صفات شاكر أبو سليمان وما يمثله في الوجدان اللبناني والمسيحي والماروني يطول بنا المقام، ولكن يكفيه من حصاد دنياه أنّه كان حقوقياً بارزاً، ومدافعاً كبيراً عن حقوق الإنسان عندما واجه إغراء شاه إيران ووعيده في آنٍ، في قضية بختيار الذي توكّل عنه وحمل السلطات اللبنانية على إخلاء سبيله. كما أنّ مروره في المجلس النيابي لم يكن عابراً، بل كان بيدره مكدّساً بغلال وفيرة من تشريعات حديثة، وقوانين عصرية. ولا ننسى أنّه من أطلق «الاتحاد الماروني العالمي» ورعاه، لكن مَن تولّوه في ما بعد لم يحافظوا عليه ولم يبكوا كما بكى ابن عبدالله على مشارف الأندلس لدى ضياع ملكه.
في الذكرى الخامسة والعشرين على غياب شاكر أبو سليمان نستعيد طلّته البهية، بسمته الساحرة، لهجته المتينية، أناقته الجاذبة، وقلبه الكبير الذي كان يتسع للفرح والحزن، وصَوته الجهوري الذي يصدح بالحق ولا شيء غير الحق.




















