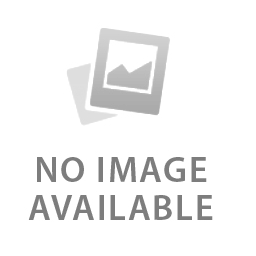

فُقِدَ الآلاف خلال التدخّل السوري الذي استمر لعقود في لبنان. وبعد أشهر على سقوط النظام السوري، لا تزال العائلات تتشبّث بالأمل.
بحثت هدى العلي عن ابنها طوال 34 عاماً، إلى أن أسلَمَت الروح. في عام 1986، حين كان في الـ18 من عمره، أوقفته القوات السورية التي كانت تحتل لبنان عند حاجز أمني واعتقلته. كانت السيدة العلي، وهي أم عزباء لـ10 أطفال، تجمع ما تجنيه بشق الأنفس من عملها كخياطة، وتسافر كل بضعة أشهر إلى سوريا المجاورة لتفتش في سجونها. وحين وهنَت ساقاها، تولّى أبناؤها المهمّة، يتتبّعون الفتات نفسه، من دون أن يعثروا على أي جواب.
ثم، في كانون الأول، ظهر فيديو. كان الرئيس بشار الأسد قد أُطيح للتوّ في هجوم خاطف شنّه المتمرّدون. وفي خضمّ الفوضى، إلتقطَ فريق إخباري يُصوّر خارج سجن سوري صورة لرجل مسنّ، أشعث الشعر ومذهول الملامح، يخرج من أبوابه. تجمّدت العائلة في مكانها. كانوا على يَقين بأنّه الإبن المفقود، علي، وسرعان ما تصدّرت قصّتهم العناوين.
لكن مضت أيام، ثم أسابيع. ولم يَعُد علي. تلاشى الأمل. لم يُقدّم المسؤولون اللبنانيّون أي توضيح. وتوقّف الصحافيّون عن الاتصال. وبعد أشهر، لا يزال البحث مستمراً.
يؤكّد شقيقه معمّر، وهو يضمّ صورة قديمة لعلي في منزل العائلة في شمال لبنان: «علينا أن نُكمِل مهمّة والدتنا. لا نزال نأمل أن يكون حيّاً».
بعد سقوط حكومة الأسد، فُتحت أبواب السجون في أنحاء سوريا، وتدفّق السوريّون إلى داخلها للبحث عن أثر لأصدقائهم وأحبّائهم الذين اختفوا بأعداد لا تُحصى في ظلّ النظام الوحشي. أمّا في لبنان، فلم يكن بمقدور كثيرين سوى أن يراقبوا وينتظروا.
اختفى مئات اللبنانيِّين خلال الاحتلال السوري الذي امتدّ من عام 1976 حتى عام 2005، ويُعتقد أنّ كثيرين منهم سُجنوا في سوريا. ولسنوات، امتدّت أذرع دولة الأسد الأمنية إلى ما بعد حدودها، واصطادت ليس فقط المعارضين السياسيِّين، بل أيضاً مدنيِّين عاديِّين وقعوا في شبكة الشكّ والاشتباه. معارضون، عمّال، رجال أعمال. كان من الممكن أن يختفي أيّ أحد.
أصبحت حالات الاختفاء علامة فارقة في الحكم السوري، أحياناً بمساعدة فصائل لبنانية مؤيّدة لسوريا، فاختُطف رجال ونساء من منازلهم أو اقتيدوا من الشوارع. خلف الحواجز، كانت أجهزة الاستخبارات السورية، المعروفة باسم «المخابرات»، تدير مراكز احتجاز في أنحاء لبنان، وأصبح فندق «البوريفاج» الفاخر في بيروت مرادفاً للتعذيب، وكان المعتقلون يُنقلون بانتظام عبر الحدود إلى سجون مثل صيدنايا.
عند سقوط الأسد، قدّرت السلطات اللبنانية أنّ أكثر من 700 مواطن لبناني لا يزالون محتجزين في سوريا، لكنّ جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان تقول إنّ عدد المفقودين أكبر بكثير. وحتى الآن، لم يَعُد سوى 9 فقط، كثيرون منهم قضوا عقوداً خلف القضبان.
من بين العائدين كان سهيل حموي، الذي اختُطف من منزله قبل أكثر من 30 عاماً. واقفاً على شرفته المطلة على البحر الأبيض المتوسط، أخذ حموي (61 عاماً) نفساً من سيجارته وتأمّل المياه الصافية في الأسفل. كان المشهد طاغياً على الحواس: لم يرَ البحر منذ 33 عاماً: «هذه المشاهد لا تتكرّر إلّا في ذاكرتك، أو في أحلامك. أشعر وكأنّي أتنفّس من جديد».
كان حموي عضواً في حزب سياسي مسيحي لبناني معارض للاحتلال السوري، واختطفه عناصر الاستخبارات السورية من منزل عائلته عام 1992 ونقلوه إلى سوريا.
كانت عملية الاعتقال مفاجئة إلى درجة أنّ زوجته ظنّت طيلة 17 عاماً أنّه اختفى فحسب. وكان ابنه، جورج، لا يتعدّى عمره العشرة أشهر حينها. وعندما عاد حموي إلى منزله، كان جورج قد بلغ الـ33 وأصبح لديه ابن.
أمضى حموي أيامه الأولى بعد الإفراج عنه يحتسي القهوة المنكّهة بالهيل، ويتحدّث عبر مكالمات الفيديو مع أقاربه، كثيرون منهم باتت وجوههم غير مألوفة بالنسبة له.
سألته إحدى قريباته عبر الهاتف وهي تجلس إلى جانب ابنتها البالغة: «هل تذكُر أولادي؟»، فأجاب حموّي بدهشة: «حين غادرتُ، كانت صغيرة جداً».
وصف سجناء لبنانيّون سابقون، في مقابلات مع صحيفة «نيويورك تايمز»، تعرّضهم إلى معاملة وحشية وتعذيب أشدّ قسوة لأنّهم لبنانيّون.
وأكّدت عائلات المفقودين أنّ السلطات اللبنانية لم تقدّم لهم أي مساعدة خلال حُكم الأسد، واضطرّوا في كثير من الأحيان إلى دفع آلاف الدولارات كرشاوى لضباط المخابرات السورية للحصول على إشارة حياة من أقربائهم أو الإفراج عنهم.
تنقّل حموي بين شبكة سجون نظام الأسد، فبدأ في فرع فلسطين بدمشق، ثم نُقل إلى سجن صيدنايا سيّئ السمعة. أمضى أول 5 سنوات في الحبس الانفرادي داخل زنزانة لا يتجاوز عرضها 30 إنشاً وارتفاعها مترَين. ووصفها بأنّها «قبر له باب. لم يكن هناك أي ضوء على الإطلاق. كنّا نميّز الليل من النهار من خلال صَوت الطيور، أو من نوعية الطعام التي كانوا يقدّمونها لنا».
في صيدنايا، توثّقت علاقته بزملائه في الزنزانة. جُرّدوا من أسمائهم وأُعطوا أرقاماً (كان رقمه 55)، لكنّ ذلك لم يمنعهم من بناء روابط خافتة، مضيفاً أنّ معظمهم لم يعِش ليشهد سقوط نظام الأسد.
اختفى صديقه السوري، وهو صحافي، بعدما أخبره الحراس بأنّ لديه زائراً. بعد 10 سنوات، علم حموي أنّه أُعدِم. وصديق لبناني آخر مقرّب، فهد، رفض تلقّي العلاج بعدما مرض بشدة، مُفضِّلاً الموت على أن يتحمّل يوماً آخر من العذاب. ويُقِرّ حموي: «كان أقوى مني. هو قبل الموت، وأنا لم أستطع».
في الأشهر الأخيرة، شكّل حُكام سوريا الجدد لجنة للتحقيق في مصير المفقودين، ضمن إطار أوسع من جهود العدالة الانتقالية. أمّا في لبنان، حيث لا تزال ظلال سوريا تُخيِّم، فالعائلات تخوض معركة موازية منذ عقود، مطالبة بالمحاسبة والحقيقة.
لكنّ نظام الأسد كان يملك نفوذاً كبيراً في لبنان، ورفض الكشف عن مصير المفقودين، وكان المسؤولون اللبنانيّون غالباً غير قادرين - أو غير راغبين - على الضغط في هذا الملف.
بالنسبة إلى عبير أبو زكي، التي كان والدها من بين المفقودين، فإنّ القضية أصبحت معركة حياة. كان ذلك في 12 حزيران عام 1987، عندما دخل والدها، خليل، إلى غرفتها في منزلهم جنوب بيروت، وطبع قبلة ناعمة على خدّها للمرّة الأخيرة.
كانت العائلة المؤلفة من 5 أفراد تستعد للانتقال إلى حياة جديدة في ألمانيا. جوازات السفر جاهزة، وكذلك تذاكر الطائرة. لكنّ خليل اضطرّ إلى القيام برحلة عمل أخيرة إلى سوريا لجلب قطع غيار شاحنات للشركة التي كان يعمل فيها. ومرّت أيام ولم يَعُد في الوقت المحدَّد لرحلتهم، فبدأ القلق يتصاعد. وتبيّن في النهاية أنّه اعتُقل لأنّه كان يحمل علبة قهوة تحتوي على دولارات أميركية، وهو أمر يُعدّ جريمة في ظلّ نظام الأسد. ثم اختفى.
في الأشهر التي تلت ذلك، انهارت العائلة. تركت والدتها، دلال، المنزل، غير قادرة على تحمّل ضغط تربية 3 أطفال بمفردها. وتحطّمت أحلامهم بحياة جديدة في ليلة واحدة.
لسنوات، وقف أبناء الطائفة الدرزية في لبنان - وهي طائفة دينية متماسكة تنتمي إليها العائلة - إلى جانبهم. ووجّه الأقرباء والمسؤولون المحليّون نداءات متكرّرة إلى السلطات السورية. وتُقرّ عبير: «الجواب الوحيد كان: نعم، هو في سجوننا. اعتبروه منّا ولا تسألوا عنه بعد الآن». وبعد سنوات، أصبح الجواب أكثر قسوة: «اعتبروه ميِّتاً»، كما تذكُر.
عندما سقط الأسد في كانون الأول، سمحت عبير لنفسها، مثل كثيرين غيرها، ببصيص من الأمل، على رغم ممّا يرافقه من تأنيب ضمير وخوف: «أشعر أنّه من الأنانية أن أتمنّى أن يكون على قَيد الحياة بعد كل هذا التعذيب. لكنّنا تألّمنا كثيراً. كنّا نشعر بالذنب إذا أكلنا أو شربنا، لأنّه لم يكن يستطيع. كنّا نشعر بالدفء بينما هو يشعر بالبرد». ثم تابعت بهدوء: «أعتقد أنّه من الأسهل أن تعرف أنّه مات».
لكنّ آخرين لا يزالون يأملون بكل قلوبهم. في منزل آل علي المتداعي في شمال لبنان، كان معمّر يضمّ صورة شقيقه علي، الملتقطة عندما كان لا يزال شاباً. وكما كانت تفعل والدتهما، بدأ يدّخر المال من أجل رحلة عبر الحدود، بحثاً عن إجابات.
ومن النافذة، كانت سوريا تُرى من بعيد. وكانوا لا يزالون يعتقدون أنّ علي، في مكان ما هناك، على قَيد الحياة، ينتظر أن يُعثَر عليه، مؤكّداً أنّ: «شعور الأم لا يُخطئ أبداً».




















