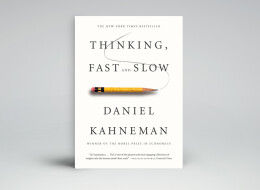نَزعُ السحر عن العالم هو من أبرز ما يتّصفُ به مشروع الحداثة، بحسب رأي دوركايهم. واستتبَع التحوّل نحو العقلانية إقصاء المقدّس، لكنّ ذلك لم يقضِ على مفهومه، بل ظهرَ مُتلفّعاً بأردية جديدة، ما يعني أنّ النفس تؤمن ولو انعدمت المواضيع الحقيقية التي تتعلقُ بالباطل، بحسب رأي باسكال.
لا يُفسَّر الإيمان وفق المنطق العقلاني بقدر ما هو حاجة لا يملك المرءُ حيالها سوى الانتساب إليها، وفق كلام الفيلسوفة جوليا كريستفيا. وهذا الرأي يتقاطَع مع ما يقوله الفرنسي فريدريك لونوار انّ «العقل المنطقي لا يمكنه أن يفسّر كلّ شيء». ويرى كانط أنَّ الاعتقاد هو موافقة كافية من الوجهة الذاتية فحسب، وإن تبدو ناقصة من الوجهة الموضوعية، غير أنّ الأزمة لا تَكمن في الحاجة إلى الإيمان أو الإعتقاد بل تَحلّ الكوارث نتيجة المساعي الرامية إلى نبذ الآخر والمشيئة الإلغائية التي ترفض من لا يؤمنُ بمَنطقها في رؤية المعطيات والظواهر.
الإنسداد العقلي
ينطلقُ التطرّف من منصّة المقدّس، سواء أكان دينياً أو غير ديني، ومن المعلوم أنّ التيارات المتطرّفة على امتداد التاريخ قد خاصمت المثل والقيَم التي تعبّرُ عن التطلّعات الجمالية لدى الإنسان، لذا يَشنّ أنصارها حرباً لا هوادة فيها على الفنّ بكلّ أنواعه، وذلك قبل أن يَطال التحريمُ ما يخالفُ تفكيرهم لنمط الحياة ومنهج التعليم ومبادئ العقيدة. وبذلك، يتمُ انسداد الأفق العقلي وتتراوحُ الاختيارات بين المحرّم والمحلَّل، ويعهدُ بحق التفكير وإرادة التصرّف بالمصير إلى فئة أو حزب أو جماعة، وهذا ليس سوى تفكير مستقيل، بحسب عبارة «جورج طرابيشي».
وفي الواقع، إنّ تفكيك ظاهرة العنف المقدَّس لا يتمّ من خلال تهميش الدين، لأنه كلّما خَلت السماء من الآلهة انقلبَ المقدّس إلى الأرض عازلاً البشر عن كل طيّباتها، ومن ثمّ يتحوّل سطح الأرض الذي يسكنه الآخرون إلى جنّة يتعذّر بلوغها، وفق رأي رينيه جيرار. كما أنّ الحداثة بوجهها التقني زادت من اغتراب الإنسان، بحيث تحوّل إلى كائن أحادي البعد وأصبح عزاؤه الوحيد هو المزيد من الاستهلاك. ولكن ماذا عن التمثّلات الأخرى للحداثة غير ما يعبّرُ عنها التطوّر الصناعي والتكنولوجي؟
تؤكد الباحثة التونسية أم الزين بنشيخة المسكيني، في كتابها «الفن والمقدس»، على أنّ نشوء مفهوم الحداثة كان من ضفّةٍ مغايرة، إذ انّ الحداثة مفهوم وَقّعه نصّ للشاعر الفرنسي بودلير، وهذا ما أقرّ به أدرونو أيضاً، لافتاً إلى أنّ صاحب «أزاهير الشر» هو مخترع الحداثة. واستَقرَأ بودلير ملامح الحداثة في أعمال الرسّام الفرنسي كوستنتين غويس الذي كان مغايراً في أسلوبه لسنن أسلافه، فقد اختار موقعه حَذو الحشود والعالم برمّته، ونقل بفنّه التفاصيل وهيجان الجموع المحبة للمساواة. وإذا نجح المرءُ في فهم مشروع الحداثة من المنطلق الفني وتم تشذيبه من الشوائب الآداتية، فهل بالإمكان مداواة العقائد الدينية من التطرّف بالحسّ الفني؟
بدايةً، لا بدّ من الإشارة إلى أنّ عملية نسف التحف والتماثيل وإحراق اللوحات الفنية تأتي دوماً من الأنظمة الشمولية والنفسيات الموتورة. فبنظر الكاتب الكولومبي إكتور آبار فاسيولينسي، «قُساة القلوب يفتقرون إلى الخيال الأدبي». وتُشير بنشيخة المسكيني إلى أنّ الحرب الثقافية، التي قام بها تنظيم داعش على متاحف الموصل ومكتبتها ومعابدها، تذكّرنا بواقعة حَرق لوحات فان غوغ وكاندنسكي وبول كلي، وإتلاف 4000 لوحة في عهد النازيين، وتحريم الموسيقى في ظلّ نظام طالبان في أفغانستان. وهنا نضيف ما تَناوَلته الكاتبة العراقية لطفية الدليمي في إحدى مقالاتها عن محاولات بعض الأطراف إزالة جدارية جواد سليم غَداةَ غزو بغداد، كما أنّ ميلان كونديرا لم يَفته التلميح إلى تطويع الفن للأغراض الايدولوجية والترويج للصَنمية في النظام الشيوعي بنسخته السوفياتية. وبدوره، توقف الكاتب الصيني دي سيجي، في روايته «بلزاك والخيّاطة الصغيرة»، عند الشبهة التي تثيرها رؤية الآلة الموسيقية لدى المأمور المَحشو رأسه بتعاليم القائد الأوحد. إذاً، فإنَّ ما يجمعُ بين الفقيه الداعشي والمأمور الشيوعي والضابط النازي والمتشدّد المذهبي والكاتب المسيحي الامازيغي ترتيليان هو كراهية الفنّ، فيما الفنان أو الشاعر برأي هولدرلين هو مَن يقتفي أثر الآلهة في الوجود حينما يطول بؤس العالم. ويقول رينيه جيرار إنّ كلّ أدب إنما في جَوهره بَحث عن المُقدّس.
بيت الوجود
قد لا يستغرق البحث عن الشواهد التي تؤكّدُ على دور الفن وتأثيره في مصير الحياة كثيراً من الوقت، فيكفي التذكير بأنّ كلمة بعض الشعراء قد كلّفتهم ثمناً باهظاً، إذ أُعدِمَ لوركا رمياً بالرصاص لأنه أبى أن يكون مُجنّداً في جيش فرانكو. كما تمكّن محمود درويش من تحويل قضية شعبه إلى سؤال وجودي مُتغلغِل في مَسامات الضمير العالمي، ما يعني أنَّ خيار الإقامة في الشعر أو الفن هو البديل للأهوال التي تداهِم البشرية. ولعلّ ما يشتركُ فيه الفن والدين هو البحث عن المعنى والانعتاق من الأطُر المحدّدة، هو ما يبحثُ عنه كلّ من الفنان والمتصوّف الذي يُبصر أبعد من القشور الظاهرية.
وأخيراً، وكلامنا يدور حول الفن، لا يَصحّ تَجاهل الموسيقى التي ترافق الشعائر الدينية بأشكال وألوان مختلفة، وتمثّلُ سمو الروح وصفاء التذوق وشكلاً لمعانقة الحياة بكل تناقضاتها. لذا، ما ان تقع على مسمعنا معزوفة لـ إلياس الرحباني، الذي رحل عن عالمنا قبل أيام، حتى نتفاعل بكل مشاعرنا مع نغمات لن يكون مصدرها إلّا عبقرية الفنان، وفي ذلك تتحقّق وظيفة خلاصية إذ يتحرّر الإنسان من إكراهات الواقع ولا تَمرّ ذكريات الماضي إلا وهي بخِفّة الفراشة. والفنان، كما يقول المفكر المغربي سعيد ناشيد، لا يقدّم الأشياء الجميلة بل يقدّم رؤية جميلة للأشياء.









.jpg?w=260&h=190&fit=crop)